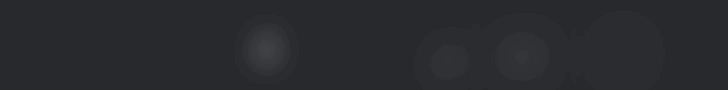الزراعة جوهر الاقتصاد الطبيعي

لقد تشكّل المجتمع البشري أساساً حول الزراعة، ولا يمكن التفكير بمجتمع بلا زراعة، إذ لا تقتصر أهمية الزراعة على قضية تأمين المأكل فحسب، بل أنها تمهد السبيل لتحوّلاتٍ وتغيراتٍ جذرية في وسائل الثقافة المادية والمعنوية الأساسية. ففي القوس الداخلي لسلسلة جبال زاغروس– طوروس والتي تُعرف تاريخياً بـ”الهلال الخصيب” وقبل خمسة عشر ألف سنة تطوّرت المجتمعات البشرية الأولى اعتماداً على الزراعة حيث تجذرت الثورة الزراعية بالاستفادة من الموارد الوفيرة، ومن ثم أدى تطوّر الزراعة إلى الاستقرار والثورة الريفية التي سبقت الثورة المدينية والتي فتحت بدورها الطريق أمام تغيّرات كبيرة في وعي الإنسان وعالمه الروحي وهو ما اصطُلح على تسميته بالثورة النيوليتية (Neolithic Revolution).
ومنذ الألف التاسع قبل الميلاد توصّل الإنسان القديم في منطقة ميزوبوتاميا العليا (كوردستان الحالية) إلى اكتشاف الزراعة حيث ظهرت البوادر الأولى للزراعة بشكل تدريجي ومحدود، وقد مثّل ذلك أول (ثورة اقتصادية) قام بها الإنسان، حيث انتقل بواسطتها من مرحلة جمع القوت والغذاء إلى مرحلة إنتاج الغذاء، وكانت الزراعة في بداية مراحلها بسيطةً وشبهَ متنقلة تعتمد على خصوبة التربة وعلى مياه الأمطار، وعلى العموم فإنّ الثورة الزراعية المتكاملة في العصر الحجري الحديث (النيوليتي) أصبحت من أكثر التحوّلات الاقتصادية والاجتماعية أهميةً في تاريخ تطوّرات المجتمع البشري القديم. حيث ظهر في تلك الحقبة الاقتصاد المنتِج المُعتمِد على تربية الحيوانات وزراعة النباتات، وقد تطوّرت الزراعة بشكلٍ لافتٍ للنظر بحدود الألف الثامنة قبل الميلاد، وفي هذه العصور كان العمل في الزراعة شيئاً مقدساً، إذ كان على المزارعين أثناء حرثهم للحقول وتجميعهم للمحاصيل أن يكونوا في حالة طهرٍ ونقاءٍ روحي، فعندما كان المزارعون يشاهدون نزول البذور إلى أعماق الأرض ويلاحظون اختراقها للظلمات لتجلبَ بشكلٍ مدهش أشكالاً جديدة ًللحياة، أدركوا أنّ هناك قوةً خفيةً تعمل، وكان المحصول بمثابة تجلٍّ وظهورٍ للطاقة الإلهية وهو ما أدى إلى ظهور عبادة آلهة الخصب والزراعة أوالآلهة الأم (عشتار–إينانا)، وبقيت ثقافة المجتمع الأمومي سائدة لفترة طويلة من الزمن، حيث تطورت الزارعة وكان تدجين وتربية الحيوانات بيد المرأة. فالاستقرار كان ضرورة قصوى بالنسبة للمرأة، إذ أن تربية الأطفال، والاعتناء بالحقول والمراعي، يتطلب الاستقرار كحاجة لا بد منها، وقد زادت هذه الظروف من أهمية دور المرأة وفعاليتها فحيث نجد الزراعة وتربية الحيوانات – والثقافة الأمومية هي الغالبة- ندرك أنّ ذاك المكان يحمل طابع المكان الأصيل الذي احتضن الثورةَ التاريخية الأولى التي تشكّلت حولها ثقافة ُعبادة الآلهة الإناث والتي انتشرت فيما بعد على أمواجٍ متتابعة.
لقد كان من نتائج هذه الثورة الزراعية أنْ تكوّنت القرى والتجمّعات الزراعية الأولى ضمن ثنائية (الزراعة– القرية) فعلى بعد 11 كم شرقي مدينة (جمجمال ) ففي جنوبي كوردستان تقع قرية (جرمو) وهي أقدم مستوطنة زراعية فلاحية في ميزوبوتاميا والشرق الأدنى، حيث اُكتشِفت في هذه القرية أمورٌ مهمة ٌمن الناحية الزراعية مثل العثور على كميات من القمح والشعير والعدس والحمص وكميات من الحبوب المتحجّرة على هيئة فحم كما وجدت بقايا عظام الماعز والغنم والخنزير والبقر، وتكشّفت التنقيبات عن ظهور نظام اقتصادي جديد يعتمد على الاكتفاء الذاتي أي أنّ كل عائلة فلاحية كانت تنتج قُوتَها بنفسها وتصنع أدواتها البدائية المحدودة، واكتشفت أيضاً مجموعة من المجارش والرحى المُستخدَمة لطحن الحبوب وأفران طينية (تنور) لطهي الخبز، ويعود تاريخ قرية (جرمو) إلى سنة 6700 ق.م، وقُدّر عدد بيوت القرية بحدود 25–30 بيتاً وعدد سكانها نحو 150 نسمة، وكان سكان (جرمو) يدفنون موتاهم تحت بيوتهم، ويصنعون أجساماً طينية للحيوانات والمرأة الحامل (الإلهة الأم) التي فُسّرت بأنها تُجسّد رمزاً للخصوبة والإنجاب وقوى الطبيعة المُوَلدة الغامضة.
وهكذا كان القوسُ الداخلي لسفوح جبال (زاغروس– طوروس )مسرحاً للثورة الزراعية قبل أن تهبّ رياحها على أوروبا بآلاف السنين، ففي هذه المنطقة كفّ الإنسان عن الاستمرار كصيادٍ متنقلٍ معتمداً على مهارته وحظه في جمع قوتِه، فبدأ بممارسة الزراعة وارتبط بقطعة أرضٍ صغيرةٍ ليخلقَ من خلال عمله في الأرض غذاءه ويصنع من الطين بيته، كما واخترع أدواتٍ جديدةً لأداء أعمال جديدة كالإبر والمسلات والمغازل التي استخدمها في الغزل والحياكة، وصارت الماشية والخراف مصدراً دائماً وسهلاً لتزويده باللحم والحليب والصوف والجلد، وفي نفس الوقت تطوّرت توجّهاته الاجتماعية، ذلك أنّ ظروف زراعة الأرض والدفاع عنها تطلبت تعاوناً جماعياً وثيقاً، وهذا بدوره قاد إلى التوجّه نحو تجمّع عدة عائلات زراعية شكلت اللبنة الأولى في جنين التنظيم الاجتماعي في مجتمع (الزراعة– القرية) الذي أنتج لاحقاً وبعد (1500–2000) سنة حضاراتِ العصر القديم (سومريين، بابليين، هوريين، حثيين، فراعنة…).
انتهى العصر الحجري الحديث في ميزوبوتاميا العليا في حدود 6000 ق.م ليبدأ العصر الحجري–المعدني أو ما يعرف في العصور التاريخية اللاحقة باسم عصر( دور تل حلف) قرب رأس العين (سري كانيه) حيث اتّسعت الزراعة وانتشرت بشكلٍ سريعٍ نتيجة التطوّر في استعمال أدوات الإنتاج المصنوعة من المعدن، وكان ذلك سبباً رئيساً في نشوء قرىً زراعيةٍ جديدة والانتقال من الاكتفاء الذاتي إلى مقايضة فائض الإنتاج الزراعي بالسلع التي تخّصّصت في صنعها فئات جديدة من الصناع والحرفيين واشتهرت هذه الفترة بصناعة الفخار الملون. لكنْ وفي نقطة زمنية محددة أدّى الاتساع في القرى الزراعية وزيادة التعداد السكاني لأن تصبح الزراعة بتقنياتها المعتمدة على الري بمياه الأمطار قاصرةً عن تلبية التطورات التي تشهدها ثقافة تل حلف، فحدث الانزياح الحضاري (الأول) في التاريخ، بأن انتقلت الزراعة إلى السهل الرسوبي في وسط وجنوب العراق (ميزوبوتاميا السفلى) حيث الأرض الخِصبة الواسعة الأرجاء التي سهلت الزراعة المعتمدة على الري وظهرت هناك مستوطناتٌ عديدة فيما يسمى بعصر( دور العبيدي) حوالي 5500 ق، أو عصر ما قبل السلالات (Pre– Dynastic)، وكان العبيديون أول من استخدم الزراعة المعتمدة على الري في (ميزوبوتاميا السفلى).
استمر العصر العبيدي إلى عهد فجر السلالات (Dynastic Age) أو عصر ثقافة أوروك (سومر) والذي يبدأ قرابة العام 3800 ق.م، حيث قام السومريون بالزراعة في السهول, واعتمدوا طريقة ريّ الحقول عبر شقّ أقنية من نهر الفرات وإيصال المياه إلى الأراضي الزراعية، وقاموا بتنظيم الري وإنشاء السدود ونمى علم الري عند السومريين، وقد مارسوا الزراعة بخبرةٍ ومهارة, فكانت أهم زراعاتهم القمح والشعير وقد تعلّموا كيف يخزنون الغلال ويستغلونها في تنمية اقتصادهم وتربية مواشيهم، كما أتقن السومريون عدة أساليب في زراعة الحبوب وفن البستنة وقد كان لاختراع المحراث اثرٌ بارزٌ في تقدّم الزراعة وقد اتخذه السومريون شعاراً من شعاراتهم المقدّسة المقرونة بالآلهة وخصوصاً إلهة (باو) إلهة الزراعة وهي أنثى، وكانت تجري في بداية موسم الحراثة من كل سنة مراسيم دينية تقليدية يقوم بها كهنة المعابد والحكام, وذلك التماساً من الآلهة بأن تجعل الموسم الزراعي الجديد مقروناً بالخير والبركة.
تطوّر الزراعة المعتمِدة على الري استوجب وجود تنظيمٍ شاملٍ، وقد تحقّق التنظيم الأمثل حول المعابد المسماة بالزقورات (وهي معابد مشّيدة على مصاطب اصطناعية، وبنيت هذه المعابد من قطع اللبن المربعة وقد وردت بشأنها تفسيرات عديدة، منها تجنّب تأثير المياه الجوفية القريبة من السطح والمخاطر “الشؤم” المتوقعة عند سقوط مبنى المعبد ارتباطاً بقدسيته، وهناك تفسير آخر وهو الاقتراب أ كثر من السماء–الآلهة وهذا ما ورد في التوراة– سفر التكوين، وكانت الزقورات تقوم بثلاث وظائف أساسية، الوظيفة الأولى تتعلّق بالقاطنين في الطابق السفلي من عمّال الأراضي، والذين يُعدّون من أملاك الزقورات، ويقيم معهم صانعو الأدوات والوسائط أيضاً، الوظيفة الثانية هي المهام الإدارية التي يقوم عليها الرهبان القاطنون في الطابق الثاني، إذ يتوجب على الراهب حساب الأعمال الإنتاجية المتعاظمة وتأمين المشروعية اللازمة (قوة الإقناع) لتحقيق العمل الجماعي بين العاملين، أما الوظيفة الثالثة فتُؤدَّى من قبل الموجودات الإلهية (مجمع الآلهة) المقيمة في الطابق الثالث.
والحال أنه وكما أعتبر العصر النيوليتي عصراً للثورة الزراعية، تربية الحيوانات، وغرس الأشجار، وبناء القرى وبناء المعابد وترسيخ أول رمز إلهي سماوي للعبادة، إنه العهد الذي عرف المجتمع الأمومي المتمحور حول المرأة والمتصالح مع البيئة، والذي ولدت فيه ثقافةُ المرأة بكل أوجها وقوّتها، والتي لايزال تأثيرها مستمراً على البشرية، فإن التمأسس التنظيمي الذي رسّخته الزقورات السومرية والقائم أساساً على تنظيم العمل الزراعي والريّ والحرف المرتبطة به, كذلك إدارة التبادل (المقايضة) في فائض الإنتاج استجلب معه البدايات الأولى لنشوء (المدينة– الطبقة– الدولة)مع بداية عصر تطوّر التجارة لأول مرة، وبروز المجتمع الأبوي، الذي يتميز بأهميته على صعيد التمهيد للمدنية، وهنا تفقد ثقافة الإلهة–الأم أهميتها، وترغم المرأة على الاعتراف بالتفوّق الحاسم للرجل، كما تقطع الإدارة الهرمية أشواطاً ملحوظة في تطورها، لتُحكِم ثقافة المدنية الناشئة هذه قبضتها على القرى الزراعية في الشمال سواء عبر الغزو العسكري أو التغلغل التجاري, وليغدو المجتمع القائم على القيم النيوليتية في (ميزوبوتاميا العليا) تابعاً للمتروبول السومري الخاضع لحكم السلالة على شكل مستوطنات كولونيالية, ولتتحقق أول هيمنة فعلية في التاريخ. وليستمرَّ هذا النمط من التنظيم الاقتصادي في عهد السلالات اللاحقة الآكادية والبابلية والآشورية والذي يرتكز على الاحتكار التجاري بعكس ما كان قائماً قبلها من احتكاراتٍ مستندةٍ على نمط الإنتاج الزراعي العبودي، ومن المفيد أن نذكر هنا، أنه بالتوازي مع حكم السلالات في (ميزوبوتاميا السفلى) كانت قبائل زاغروس (الآرية) تشكل حلفاً فيدرالياً كضربٍ من ضروبِ الحضارة المضادة أو الموازية في ميزوبوتاميا العليا والتي تمكنت في العام 2150 ق.م من القضاء على السلالة الآكادية بقيادة ملك الكوتيين الشهير (خودا)، ويلاحظ بأن هذه الجماعات (القبائل الآرية) المجتمعة تحت اسم الهوريين (لفظ أطلقه عليها السومريون) في أعوام 3000 ق.م، قد أسّست صوب الشمال اتّحادين سياسيين منيعين أحدهما باسم الحثيين، ومركزهم (كانیش)، والثاني باسم الميتانيين ومركزهم واشوكاني (سري كانيه أو رأس العين)، وقد اتّسمت هذه القبائل بإبداعها ثقافةَ زراعيةً أكثر رسوخاً، وأسست شبكة قرى مكثفة للغاية، وشارفت على عتبة التمدّن.
وفي نفس الوقت الذي كان التنظيم الاقتصادي يزدهر في حوض ميزوبوتاميا حول المعابد والسلالات الحاكمة، كان حوض النيل يشهد نهضة اقتصادية زراعية بالاستفادة من مياه النيل، وتميّز التنظيم الاقتصادي لدى الفراعنة (بدءاً من 4000 ق.م) عمّا كان سائداً في سومر من نظام عبودي، وتمّيز نمط الإنتاج في مصر القديمة بوجود دولةٍ مركزيةٍ قويةٍ تملك وسائل الإنتاج الرئيسة، وبخاصّة الأرض، كما تقوم الدولة بمهمات اقتصادية عليا، وتستغلّ الفلاحين المنضمّين إلى مشتركات قروية شبيه بـ (الكومونات المشاعية)، وهي عبارةٌ عن وحدة إنتاجية في المجتمعات القديمة حيث يملك أهل القرية مثلاً الأرض التي تحيط بهذه القرية جزئياً أو كلياً، ويُعتَبر هذا النمط من الإنتاج متقدّماً عما كان موجوداً في ميزوبوتاميا فالقرى عبر مشتركاتها (كوموناتها) تنتفع بالأرض بصورةٍ مشتركةٍ ممّا يوحي بتباشير ولادة مجتمع لا طبقي, أعاق ظهوره وجودُ أقلية تمارس سلطة الدولة المركزية مما يعيد المجتمع لحالة الفرز الطبقي، هذه الحالة ولدت حالة ديالكتيكية في نمط الإنتاج في المجتمع الفرعوني، حيث كان يحتوي على المشاعية وعلى بذور العبودية، بل والإقطاع والعمل المأجور، ومع أنّ الأرض كانت ملكاً ( لفرعون) كرأس للدولة من الناحية النظرية، إلا أنّ حقّ الانتفاع بها كان مقرّراً لأفرادٍ عديدين وكان هذا الحقّ يُورَّث أو يُؤجَّر أو يُباع.
لقد كان الإنتاجُ الزراعي هو الأساس في الاقتصاد الفرعوني، وكان هيكلُ الإنتاج هو الذي يحدّد هيكلَ التوزيع تحديداً كاملاً. وينقسم ناتج العمل الفلاحي إلى قسمين، قسمٌ يغطي متطلبات الإنتاج واحتياجات المنتجين ضمن (الكومونة)، أي تحقيق الاكتفاء الذاتي، وقسم آخر يُسلَّم للدولة على شكل ضريبة عينية من مختلف المنتجات الزراعية وبخاصة الحبوب.
على الضفة الأوروبية، وفيما سُمي بعهد الأبطال (1300–1100) ق.م, عاش اليونانيون أو (الآخائيون)– كما أسماهم هوميروس– حياة محلية فقيرة فكرياً, إلا فيما يتعلّق بالحروب والغزوات, وكانت الأرض ملكاً للأسرة التي كان أفرادها يصنعون ما يحتاجون إليه بأنفسهم, حيث كانت الأسرة في ذلك العهد تنتج ما تستهلك, وتستهلك ما تنتج, حتى أنّ ملكاتٍ وأميراتٍ ( كهيلين وأندروماك) كنّ يشتركن مع خادماتهن في الحياكة والغزل, أما أوذيس (الإله) وبحسب الأوديسا فإنه كان يصنع الأثاث لمنزله ويفاخر بمهاراته في الأعمال اليدوية. ولم يذكر هوميروس شيئاً عن النقود, فالثروة عند الآخائيين كانت تُقاس بعدد رؤوس الماشية وليس بكمية المعادن, وكانت الأبقار وحدة قياس للتبادل.
وفي مرحلةٍ أخرى من مراحل تطوّر هذه الحضارة بدأت الملكية الفردية بالظهور، وبدأ اهتمام (الآخائيين) يزداد تدريجياً بالزراعة وريّ الحقول، فضلاً عن امتلاكهم لقطعان الماشية، معتبرين بذلك الزراعة نوعاً من أنواع النشاط النبيل. كما تُظهر كتابات هوميروس الشكل الأول للتخصّص الحرفي، فيتحدث عن البنّائين والنجّارين الذين يشتغلون في بيوت من يطلب منهم ذلك، وليس للبيع في السوق. والصنّاع في ذلك العهد كانوا أحراراً، أما الرقّ فكان قليلاً ومقتصراً على أسرى الحروب. كما تطوّر التبادل التجاري، حيث حلّت النقود المعدنية محل الماشية كوسيلة للتبادل، إذ صُنِعت سبيكة من الذهب بوزن (57 رطلاً) أطلق عليها اسم (تلانتون) وتعني الوزنة، ولكن ظلت الماشية مقياساً للثروة. وفي مرحلة لاحقة ما بين (1100–600) ق.م تطورت الحياة الاقتصادية والسياسية والفكرية في بلاد اليونان، حيث ظهرت حضارات المدن أو كما يسميها المؤرخون (دولة المدينة) حيث اُعتبِرت كل مدينة منها وحدةً سياسية واقتصادية وعسكرية تتمركز حول المعبد، وكل واحدةٍ أو مجموعةٍ من المدن تشكل دولةً قائمة بحدّ ذاتها، وتدريجياً ازدهرت الملكية الفردية وتوسّعت الفوارق الطبقية في (دول المدينة)، فأصبحت الثروة تُقاس بامتلاك الأموال المنقولة التي يتمّ جمعها عن طريق المبادلة الداخلية أو التجارة البحرية وهو ما أدّى إلى تعدّد الطبقات في مجتمع تلك الفترة وظهور النبلاء كأسرٍ تمتلك أراضي واسعة وتتمّتع بنفوذٍ سياسي في المجتمع، أما أصحاب المهن من أطباء وفنيين وحرفيين و… الخ فكانوا يتوارثون المهنة ويحافظون على سرّيتها وهم أقلُّ شأناً من النبلاء، ثم كان هناك العمال الذين يشكلون النسبة الأعلى من الشعب ويعملون من حين لآخر مقابل طعامهم ولباسهم، ثم يأتي الأرقاء وهم أسرى الحرب في أسفل الهرم الاجتماعي وكانوا يُباعون ويُشتَرون حسب قوّتهم ومهارتهم.
لقد تجلّى التطور الاقتصادي لبلاد اليونان مع بداية القرن الخامس قبل الميلاد باتساع المدن وازدياد عدد سكانها وظهور مدنٍ جديدةٍ نشأتْ فيها طبقة ٌمن التجّار والصنّاع، بالإضافة إلى اعتماد النقد كوحدةٍ أساسيةٍ للمبادلة واحتساب الثروة. ولاحقاً تطورت الكثير من المعايير الاجتماعية والاقتصادية والثقافية تماشياً مع واقع الحياة المتجدّد آنذاك، فلقد شكلت المدينة اليونانية وحدة سياسيةً–اقتصادية ًمتكاملةً، تجمع بين زراعة الحبوب والزيتون وصناعة الجلود والفخار، وهي كانت مأوى جميعِ الطبقات، يعيش فيها السادة ومُلاك الأرض والتجّار وأصحاب الحِرف. وإلى جانب كونِ المدينة موطنَ أدب السلوك والفلسفة والشعر والتمدّن فهي أيضاً موطنُ الخير والإنتاج وأروع المظاهر الريفية، فعلى بُعدِ خطواتٍ من أسوار (أثينا) كانت تُشاهَد بساتينُ الزيتون والكروم والحقول المزروعة بمختلف أنواع الحبوب والأعلاف، وعلى مَرمى البصر من المدينة تواجدت مراعي الأغنام، ففي كتابه المعنوّن بـ (حول وسائل تحسين إيرادات دولة أثينا) يدرس المُؤرِّخ الإغريقي إكسينوفون (440– 355) ق.م مصادر الرخاء النسبي للمدينة ووسائل تعزيزه ويعزو الرخاء إلى تفوّق الزراعة المحيطة بها.
وهكذا ظلت الزراعة مهنة اليونان الوحيدة خلال قرون عدة، وحتى عندما بدأت التجارة والصناعات الحرفية بقي للزراعة مكانتها المرموقة، إذ أن الزراعة كانت تعتبر المهنة الوحيدة المناسبة للمواطن اليوناني. ذلك أنّ الاقتصاد اليوناني كان اقتصاداً زراعياً بصفةٍ أساسية، فقد احتلت الزراعة في حياة اليونانيين أهميةً جعلتها تُستثنَى من الاحتقار العام للنشاط الاقتصادي. وقد نُسب إلى سقراط بأنه قال: “سوف تتملكني الدهشة والاستغراب فيما إذا علمتُ أن رجلاً ذا أحاسيسَ حرّةٍ قد وجد لوناً من ألوان النشاط أكثرَ جاذبية ًمن الزراعة”.
بموازاةِ هذا التركّز والتمأسسِ الاقتصادي في المدينة اليونانية كان الفكرُ الاقتصادي ينمو ويترعرع في أحضانِ الفلسفة الإغريقية، فالتحليل الاقتصادي لأرسطو (384– 322) ق.م ارتكز مباشرة ًعلى الحاجات وإشباعها عن طريق الحصول على الأموال، عبر ممارسة الزراعة والصناعة وتربية المواشي والصيد، إلى جانب التجارة، ويعتقد أرسطو أن العائلةَ هي الوحدةُ الإنتاجيةُ التي تعمل على تحقيق اكتفائها الذاتي، كما أقرّ أرسطو بوجود الرقيق (العبيد)، ذلك أنّ الأفراد مختلفون في قِواهم العقلية والفكرية، فخُلِق فريقٌ منهم سيّداً وخُلِق فريقٌ آخر مَسوداً رقيقاً. (ومن امتاز من الفريق الأول بالعقل وسمو الإدراك صَلُح للحكم، أما الباقي من هذا الفريق فعليه أن ينفّذ أوامر الحُكّام ويطيع ما يصدرونه من أوامرَ وتعليمات)، كما احتقر أرسطو كل المهن التي تتصل بإنتاج الثروة وقال: “إنها من أحقر وظائف الأسرة مع اعترافه بضرورتها”، وخصّص العبيد والأجانب (غير اليونانيين) للقيام بهذه الحرف والمهن، كما أكّد على أنّ: “العمل في الزراعة وتربية الحيوان والصيد في البر والبحر أشرف من الاشتغال في التجارة”.
أما الرومان فلم يضيفوا لنتاج اليونان شيئاً يذكر على صعيد الفكر الاقتصادي, فقد اقتصرت مساهمتهم في الثناء على الزراعة, حيث أضافوا مقترحاتٍ كثيرةً بشأن أساليب الزراعة وإدارتها كالدورة الزراعية وتخصيب التربة وتطعيم الأشجار، إضافة للقوانين الاقتصادية التي أثّرت في الفكر الاقتصادي في مراحلَ تاليةٍ، والمقصودُ هنا هو فكرة القانون الطبيعي التي احتلّت مكانةً بارزة ًفي الفكر الاقتصادي في القرن الثامن عشر.
ومع بدء الميلاد وحتى نهاية العصور الوسطى سادت مواضيعُ من قبيل جمع الثروة وشرعيةِ كسب النقود والفائدة (الربا) وحق الملكية وتشغيل العبيد على الفكر الاقتصادي الذي بقي يترعرع في ظل الكنيسة، لكنّ الشيءَ اللافت في هذه الفترة هو تطور وسائل الإنتاج وانتشار الحرف على نطاقٍ واسع ٍ, كذلك ازدهار التجارة بين الأمم، فمع بدءِ عصر النهضة والاكتشافات الجغرافية وحركة الإصلاح الديني حدثت النقلةُ الثالثة في تاريخ الاقتصاد, وذلك بعد التمايز الطبقي في ( ميزوبوتاميا السفلى) ونشوء المدنيّات اليونانية، إنّ المقصودَ هنا هو نشوءُ الرأسمالية التجارية في الممالك والأمم الأوربية مثل إنكلترا وهولندا وإيطاليا وإسبانيا، وهو ما يُعرَف بالتيار المركانتيلي (كلمة مركانتيلية جاءت من الإيطالية وتعني تاجر–Merchant) التي ظهرت بوادرها مع بداية القرن السادس عشر، لقد نشأ هذا التيار من رحم مفهوم (الدولة القومية) الناشئ في أوروبا، حيث الرابطةُ الحميمية ُبين سلطة الدولة ومصلحة التجار، ومن ثَمَّ كان هدف المركانتيلية هو إغناء الأمة والأمير الذي يوجد على رأسها ومن أجل تدعيم القوة السياسية والاقتصادية للدولة، لذلك فقد تركّز الاهتمام على المُستعمَرات وثرواتها وقد ساد خلال هده الفترة الإتجاهُ نحو كسبِ مزيدٍ من المُستعمَرات وتقويةِ الدولة ومؤسّساتها. ويقوم هذا الفكرُ على مبدأين أساسيين، الأول: يربط قوة الدولة بما تتوفر عليه من معادن نفيسة، والثاني: توجيه الدولة للاقتصاد وذلك بخلق صناعاتٍ محلية ٍلضمان القدرة على المنافسة الخارجية وضمان الأسواق مما يفرض على الدولة مراقبة َجودة المنتوجات الصناعية عن طريق سَنِّ قوانينَ صارمةٍ.
وهنا قد يخطر على بال القارئ أنْ يتساءل، لماذا لم تبلغ المدنية اليونانية ومن بعدها الرومانية وحتى إقطاعيات العصور الوسطى إلى مستوى الرأسمالية المتحقق في مطلع القرن السادس عشر؟ والإجابة على هذا التساؤل هي أنّهُ وبالرغم من تطوّر الحرف والتجارة في العهدين الإغريقي والروماني إلا أنّ رَجَحان كفّة الزراعة في حجمها ووزنها قد حالَ دون حصولِ التراكم الرأسمالي الذي أنجزته المركانتيلية ولا ننسى الحروبَ الدينية التي أفضتْ بالجميع لأنْ يخرجوا منها مُنهزِمين. وغنيٌّ عن البيان أنّ المركانتيلية كانت تنطوي على اختلافٍ واضح ٍمع المواقف والوصايا الأخلاقية لأرسطو والكنيسة والعصور الوسطى بوجهٍ عام، ولمّا كان التجار يسعَون للثروة في مجتمع ٍهم فيه أصحابُ النفوذ والسادة، فإنّ هذا المسعى قد فقد دِلالته الشريرة، وربما تكون (البروتستانتية ) ساعدت على ذلك، فالعقيدة الدينية– كما هو عليه الحال دائماً– تتكيف مع الظروف والاحتياجات الاقتصادية.
ويتسارع التمدّن في أرجاء أوروبا ليعمّها، ولأول مرة شرعتْ المدن تجهد للتغلّب على الزراعة، وتتحول الملكيات الإقطاعية إلى دول مونارشية عصرية، إذ أدّى التراكم الرأسمالي الأول الكبير لأوروبا دوراً رئيساً فيما بين القرنين الخامس عشر والثامن عشر، حيث بسط هيمنته لأول مرةٍ على الزراعة والمهن الحرّة المتنامية في المدينة منذ القرن العاشر، وغلب الطابع الاحتكاري على المصانع باعتبارها أول حركة ٍصناعيةٍ جدية، وهذا الذي سُمِّي بالثورة الصناعية ,ولم يكن في الحقيقة خارج السياق التاريخي للتطور الصناعي، فلطالما وُجِدت الصناعة ُعلى مرِّ التاريخ، فاكتشاف ُالزراعة يُعَّد بمثابة ثورة ٍصناعيةٍ ضمن مجالها، والحرفة أيضاً صناعة. بمعنىً آخر، أنّ كل وسيلةٍ أو أداةٍ أو معرفةٍ أو أسلوبٍ جديدٍ معنيٌّ بالإنتاج يكافئ تطوراً في الصناعة، وتتجسّد أهمية الصناعة المتحققة مع حلول القرن التاسع عشر، في الربح، أي تربّع رأس المال في المقام الأول من حيث المَكسَب، والحديث المُسمَّى بالثورة ما هو إلا تضخيمُ الأرباح التي يُدرِّها الإنتاج الصناعي بسرعةٍ مذهلةٍ نسبةً إلى المكاسب والأرباح التي تُجنَى من التجارة والزراعة، فالإنتاج الصناعي أصبح يستلم زمامَ الريادةِ لأول مرةٍ في التاريخ، هذه هي الظاهرةُ القابعةُ في جوهر الثورة الصناعية، ففي السابق كانت الزراعةُ والورشة ُميدانين للإنتاج التقليدي، والتجارة كانت على شكلِ تبادلٍ للسلع اعتماداً على فائض الإنتاج في كلتا الساحتين، هكذا كان جوهر النشاطات التي تُسمَّى اقتصاداً.
ومع الثورة الصناعية وتَرسُّخ الرأسمالية الصناعية في بريطانيا كانت الولادةُ الحقيقية لعلم الاقتصاد أو (الاقتصاد السياسي) فالمدرسة الكلاسيكية التي نشأت على (يد آدم سميث) ومن بعده دافيد ريكاردو وروبرت مالتوس وغيرهم والتي نادت بالحرية الاقتصادية وتغليب المصلحةِ الفردية، تُعتبَر الإطار الفكري للثورة الصناعية، التي أدّت ولأول مرةً في التاريخ لأنْ يتفوّق الإنتاج المديني على الريفي، فقد كان الحرفي أو المهني المديني منتجاً معاوناً للريف طيلة آلاف السنين لا بل ومعتمداً بوجوده على الريف، لكنّ الثورة الصناعية قلبت هذه الآية رأساً على عقب، حيث بدأ مجتمع القرية يُستعمَر على يد مجتمع المدينة بدءاً من الميدان الإيديولوجي إلى وسائل الإنتاج ومن الأخلاق إلى الفن وهو ما مهّد لثورة ذهنية رسّخت انتصارَ البرجوازية على كلِّ الطبقاتِ الأخرى.
أمّا في فرنسا فبالرغم من أنّ الرأسمالية التجارية والثورة الصناعية قد لاقتا الازدهارَ كما بقية الأمم والممالك الأوروبية، بَيدَ أنَّ تضافرَ مجموعةٍ من العوامل السياسية والاقتصادية والفكرية أسبغت على هذا البلد الأوروبي طابعاً خاصاً، حيث احتفظت فرنسا وعلى مدىً أوسع من أيِّ بلدٍ أوروبي آخر باهتمام خاص بالزراعة وظل للزراعة فيها سحرُها الخاص، فالزراعة لم تكن مجردَ حرفةٍ بل يمكن تسميتها بـ”طريقة حياة”، وظلت المصالح الزراعية تحكم فرنسا وكان الأرستقراطيون ومالكو الأرض هم الذين قد أحاطوا بخلفاءِ لويس الرابع عشر في فرساي، مُتمتّعين بالأسبقية الاجتماعية، وحدث أنْ اقتحم الفكر ما تحققه ملكية ُالأرض من ثروةٍ وما تُرسيه من أعراف، ومن هذا الاقتحام جاء في النصف الثاني من القرن الثامن عشر إسهامٌ فرنسيٌ مُبتكَر في الفكر الاقتصادي، بروح “التنوير” وكتابات فولتير وديدرو وكوندورسيه, وروسو، وكان من الأمور المحورية دورُ الزراعة بوصفها المصدرَ لكلّ الثروة، وقد سُمِّي أصحاب هذا الفكر الاقتصادي بالطبيعيين أو الفيزوقراط.
ويعود لأحد منظري المدرسة الفيزوقراطية (فرانسوا كينيه) القانونُ الطبيعيُّ الذي يرى في الزراعة على أنّها القطاع المُنتج الوحيد وأنّ الثروة الحقيقية كلَّها تنشأ من الزراعة، فقد استطاع الفيزوقراط تكييفَ التطورات في الأسواق التجارية كذلك الثورة العلمية التي أفضتْ إلى الثورة الصناعية لخدمة الزراعة وتطويرها، حتى أنّ آدم سميث الأب الروحي للاقتصاد الرأسمالي قد علّق على شغف علماء الاقتصاد الفرنسيين (الفيزوقراط) بالزراعة وتركيزهم على اعتبارها مصدر الثروة الوحيد فقال: (إنهم رجالٌ ذوي قدرٍ كبيرٍ من المعرفة والبراعة).
وبالرغم من أنّ الأفكار الطبيعية للفيزوقراط لم تستطع الصمود أمام المد الثوري للثورة الفرنسية (1789) لكن مذاك الحين تميّزت البرجوازية الفرنسية بأنها برجوازيةٌ زراعيةٌ، حيث استطاعت الاحتفاظ بمكانتها الاجتماعية وأسبقيتها ولم تتنازل لمصالح التجّار والصناعيين كما حدث في أوروبا الشمالية وإنكلترا على وجه التحديد، كذلك قيمُ الحداثةِ الرأسمالية كان لها تميّزها في فرنسا، هذا التميّز الذي أنعكس في نتاج ِعلماء الاجتماع الفرنسيين، ولاحقاً بُنيَت طريقة العيش والأعراف الفرنسية بناءً على قيم الأرض والزراعة، فإلى اليوم يُسعِد المزارعين عند اجتماعهم في أعيادهم وصلواتهم أنْ يسمعوا أدعية ًوبركاتٍ تقول أنّهم وأنشطتهم الزراعية أساس ُكلِّ تقدمٍ اقتصادي وكل قوةٍ وفضيلة ٍوامتيازٍ على المستوى الوطني.
إنّ الحداثةَ الرأسمالية َالمتصاعدةَ في أوروبا والمُستندة لاحتكار الدولة القومية التجاري والصناعة التي تنمو كل يومٍ عبر توظيف طاقة الفحم الحجري والنفط لاحقاً والعلم والتقنية إضافة لجيوش العمال, وبالرغم من أنّها أحدثت ثورةً في الإنتاج البضاعي، إلا أنها أدّت في الآن ذاته إلى آثار سلبية على المجتمع والبيئة على صعيد تفكيكها وتمزيقها وتشتيتها إيّاهما، فالحالُ الراهنُ للبيئة يدلُّ على أنّ الخطرَ لا يحدق بالمجتمع وحده، بل بالحياة الحيوية بأكملها، فالصناعة الخاضعة لهيمنة رأس المال– الربح، حوّلت العالمَ إلى جهنم بالنسبة للإنسانية جمعاء، فيما عدا حفنة من الاحتكاريين، ومن غير الممكن إنكارُ كون ِهذا الوضع قد أصاب البشرية بالقلق والمخاوف، فقد أُسِّسَت إمبراطورياتٌ حقيقيةٌ مسلطة على المجتمع كاحتكار ٍصناعي.
لقد أصابت الصناعوية ُ الزراعة َفي مكمن الروح، فالزراعة التي هي العامل الأصيل للمجتمع البشري ووسيلة وجوده، تشهد دماراً مَهُولاً تجاهَ الصناعة، هذا النشاط المُقدَّس الذي أوجد البشرية على مرّ خمس عشرة ألف سنة قد تُرك وشأنه في اليوم الحاضر، تهيئة ًلإخضاعه إلى سيطرة الصناعة، فعندما تدخلت الصناعة التابعة لرأس المال– الربح ميدان الزراعة، فمن المُحال تقييمها كإنتاج سريع ووفيرٍ كما يُعتقد، فالزراعة ليست فقط أيّة أداة أو علاقة إنتاجية كأي شيءٍ آخر، بل هي أجزاءٌ من وجود المجتمع وكيانه، لا تتجزّأ ولا تُعدَّل البتة، وقد أُنشئ المجتمع البشري عن طريق الأرض والزراعة بنسبة عُليا، وبتره من تلك الأماكن ومن الإنتاج يعني إلحاق الضربة الساحقة بوجوده، وحقيقة المدينة المُتضخِّمة كالسرطان تستعرض هذا الخطر منذ الآن بشكل مكشوف. إذ أنّ تحوّل علاقات القرية– المدينة المتأسّسة طيلة َالمجتمع التاريخي على التناغم وتقسيم العمل فيما بينهما إلى تناقضات متجذرةٍ، واختلال التوازن على حساب مجتمع القرية– الزراعة متعلّقٌ أيضاً بإخضاع الاقتصاد للترتيبات الهادفة إلى الربح، فتَخلّي العلاقات المُعتمِدة على التغذية المتبادلة بين المدينة والقرية، وبين الزراعة والحرف الحرة والصناعة عن مكانها لعلاقات تصفية بعضها البعض، إنما هو نتيجة وخيمة أخرى من نتائج قانون الربح الأعظمي، إذ ولجت المدينة والصناعة مرحلة التعاظم السرطاني، ولدى الزجِّ بمجتمع القرية والزراعة إلى حافة الفناء والانتهاء، مما ترك المجتمع التاريخي بذاته– وليس الاقتصاد وحسب– وجهاً لوجه أمام الفناء. أما الخلاص، فيُرى كاحتمالٍ كبيرٍ وبنسبةٍ مرتفعةٍ في حركةٍ معاكسة، إنها حركةُ العودة من المدينة إلى الأرض والزراعة
إن التطور الاقتصادي– الصناعي الذي شهده العالم خلال المائتي عاماً المُنصرمة أحدث آثاراً مدمّرةً في المنظومة الإيكولوجية للعالم، والتي استغرقت ملايين السنين حتى تشكّلت، بحيث أنّ هذا التطور أصبح مشكلةً وجودية ليس للإنسان فحسب بل للمحيط الحيويّ كاملاً، إذ يتجلّى التهديدُ على وجه الخصوص في كون المستويات المرتفعة للنشاط الصناعي تسببُ ارتفاع درجات الحرارة وتؤدِّي إلى تغيراتٍ فجائية ٍوسريعة ٍفي المناخ، إضافة ًإلى نفاذ غشاء الأوزون وتدمير الغابات المطيرة والتصحّر وتسميم المياه والتربة، بحيث تؤدي إلى أنْ تصبح الطبيعة عاجزة ًعن القيام بما كانت تقوم به منذ الأزل، أي عمليات التجديد الحيوي.
وعليه فإنّ هذه التطورات تفرِض، إمّا إبطاءَ نموُّ النشاط الصناعي إلى درجة تتوافق مع متطلبات الحفاظ على البيئة، أو على نحوٍ يتيح للطبيعة إصلاحَ ما أفسدته يد الإنسان، فالأرض والزراعة أعدّتا نفسيهما إيكولوجياً خلال ملايين السنين، ومن المُحال إنشاؤهما بيد الإنسان في حال فسادِهما، كما أنّ هذا الإبطاء مستحيل في ظل النظام الاقتصادي العالمي الذي يشكل مثلُ هذا التباطؤ موتاً حقيقياً له، وهو غيرُ قابلٍ للتحقيق في ظل النمو الديمغرافي الهائل وتنامي عدد سكان الأرض بشكلٍ لم يسبق له مثيلٌ في التاريخ. وإمّا تعديل التكنولوجيا وأنماط التطور وعقلنة النشاط الاقتصادي ونمط معيشة الإنسان الحديث عموماً، بشكل ٍيجعله يتصالحُ مع البيئة في سبيل خدمة المصالح الحقيقية للمجتمعات البشرية وللأجيال الحالية والقادمة. فلا يمكن لطبيعة المجتمع تأمينُ استمراريتها إلا ضمن علاقاتٍ وثيقةٍ مع البيئة، ولا يمكن لأيِّ تكوينٍ صناعي أنْ يقوم مقامَ البيئة بوصفها معجزةَ الكون.
بقلم: ﭼﻠﻨﮒ عمر